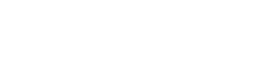محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 36 - مباحث الملازمات العقليّة
الباب الثالث / مباحث الملازمات العقلي
مباحث الملازمات العقليّة
- الملازمة العقليّة
- الإجزاء
- مقدّمة الواجب
- النهي عن الضدّ
- اجتماع الأمر والنهي
- اقتضاء النهي الفساد
توطئة:
أبنت في تحديد موضوع علم اُصول الفقه انّ هذا العلم يبحث في موضوعين، هما:
1- الظواهر اللغويّة - الإجتماعيّة.
2- الظواهر الإجتماعيّة - الإجتماعيّة.
ومن خلال تطبيقهما على الأدلّة الشرعيّة وشؤونها.
وقد انتهينا في مباحث دلالة الألفاظ من الموضوع الأوّل.
وفي هذه المباحث الآتية (الملازمات العقليّة) و (الاُصول العمليّة) ننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو: الظواهر الإجتماعيّة - الإجتماعيّة، مبتدئين بما أطلق عليه الاُصوليون عنوان (الملازمات العقليّة)، ويعنون بها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
ومؤدّى هذه الملازمة: أنّه متى حكم العقل بحسن شيء أو قبحه حكم الشرع على طبق حكم العقل.
أي انّ حكم العقل يلازمه عقلا حكم الشرع.
يقول اُستاذنا المظفّر(1) -: أي انّه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا - بما هم عقلاء - على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، فانّ الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع فلابدّ أن يحكم الشارع بحكمهم، لأنّه منهم، بل رئيسهم، فهو - بما هو عاقل، بل خالق العقل - كسائر العقلاء لابدّ أن يحكم بما يحكمون.
ولو فرضنا انّه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع، وهذا خلاف الفرض.
والعكس صحيح، أي إذا حكم الشرع بشيء حكم العقل به.
يقول السيّد السبزواري في (التهذيب)(2): وهي - يعني قاعدة الملازمة - أنّه كلّ ما حكم به الشرع يحكم به العقل.
وهذه القاعدة قديمة جدّا، بل كانت في قديم الأزمان معتقد بعض أعاظم حكماء اليونان، وتظهر من كلمات أهل العرفان حيث يقولون:
إنّ العقل شرع داخلي، والشرع عقل خارجي، ولا فرق بينهما في حاق الواقع، فلو تجسّم العقل لكان بصورة النبي، كما لو تجرّد النبي لصار العقل بعينه، بلا فرق بينهما إلا بإختلاف النشأة والعالم.
فإذن، فحوى هذه الملازمة هي:
- كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع.
- وكلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل.
أي انّ حكم كلّ منهما يلازمه حكم الآخر.
وقد بحثت هذه الملازمة في الفلسفة اليونانيّة والفلسفة الإسلاميّة وفق المنهج الفلسفي، وفي علم الكلام وفق المنهج الكلامي.
وكلا المنهجين عقلي يعتمد ويلتزم المبادئ العقليّة.
ونقلت المسألة إلى علم اُصول الفقه وبحثت فيه وفق المنهج العقلي أيضا.
وهنا - أي بالنسبة إلينا - يأتي دور التجربة الرائدة وذلك بتناول المسألة وفق المنهج العلمي.
ومبرّر العدول عن المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي - بالإضافة إلى ما بينهما وبين المنهج العلمي من فارق - هو أنّ القوم ربطوا المسألة بفكرة التحسين والتقبيح من منطلق خلافهم فيهما: هل هما عقليّان حكم بهما العقل بما لازمه - عقلا - حكم الشرع، أو هما شرعيّان فما حسن الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح؟
والذين استدلّوا بأنّهما عقليّان بدليل تباني العقلاء على مدح فاعل الحسن وذمّ فاعل القبيح، وأنّ المشرّع سيّد العقلاء ورئيسهم، تسلّمهم هذه النتيجة - قهرا - إلى انّ الحسن والقبح شرعيّان، ولكن الوصول إليها كان عن طريق تباني العقلاء، لا بشكل مباشر، أو عن طريق النصوص الشرعيّة.
ولهذا عدل بعضهم إلى القول بانّ الحسن في الأشياء الحسنة ذاتي وكذلك القبح في الأشياء القبيحة ذاتي يدرك بالوجدان بأدنى التفاتة من الإنسان.
وترجع تلكم المفارقة إلى انّهم فهموا من العقل الحاكم بالملازمة، أو المدرك للاستلزام هو بناء العقلاء.
وهو في الواقع - غير هذا، ذلك انّ المراد به هنا الإدراك البديهي الذي قد يعبّر عنه بالوجدان في مقابل البرهان الذي هو إدراك نظري.
وكما توخّى البحث في دلالة الألفاظ:
- دراسة قاعدة الظهور.
- ودراسة مواردها من مفردات ومركبات.
يتوخّى البحث الاُصولي - هنا -:
- دراسة قاعدة الملازمة.
- ودراسة مواردها، المتمثلّة في الظواهر التالية:
1- الإجزاء.
2- مقدّمة الواجب.
3- الضدّ.
4- إجتماع الأمر والنهي.
5- دلالة النهي على الفساد.
الموضوع العامّ لهذه المسائل:
أوضحت - في أعلاه - أنّنا في البحث نبحث المسائل الخمس، وتعقيبا عليه لابدّ من الإشارة إلى أنّ الاُصوليين اختلفوا في تصنيف هذه المواد، لاختلافهم في دليل حكمها:
- فمنهم من سلكها ضمن موضوعات مباحث الألفاظ.
ومن أبرز هؤلاء الآخوند الخراساني في (الكفاية).
- ومنهم من استقلّ بها في هذا الباب (باب الملازمات العقليّة).
ومن هؤلاء شيخنا المظفّر في اُصوله والسيّد السبزواري في تهذيبه.
ولأجل أن نجمع بين الحقّين ونكون مع الطرفين نبوّبها مستقلّة ونستدلّ عليها بالدليلين اللفظي والعقلي.
الملازمة العقليّة
سوف نتناول تعريف هذه القاعدة من خلال ملاحظة السلوك الإجتماعي لتعامل الناس مع هذه القاعدة.
ومن بعد ننتقل إلى الجانب التطبيقي في المسألة.
وقبل التعريف نوطئ ببيان المراد من كلّ من مفردتي العنوان:
الملازمة.. العقل.
(الملازمة):
الملازمة: inherence
لغة: امتناع إنفكاك الشيء عن الشيء.
وعلميّا: كون الحكم مقتضيا للآخر على معنى انّ الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر إقتضاءً ضروريا، كالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل(3).
ويراد بها - هنا – (الإستلزام (Toimply وهو - كما يعرفه صحاح المرعشليين - ترتّب نتيجة حتميّة على أمر آخر عقلا أو تجربة.
وهذا الإستلزام من أوضح الظواهر الإجتماعية (العرفيّة) التي قامت عليها حياة الناس في أعمالهم ومعاملاتهم.
(العقل):
يراد به - هنا - القوّة الذهنيّة التي تدرك الإستلزام المذكور وبالبداهة، أي من دون إعمال فكر.
فمتى أدرك الإنسان انّ هذا الفعل واجب عليه، وهذا الفعل لا يمكن تحقيقه خارجا إلا بالإتيان بمقدّمته، يدرك بالبداهة استلزام تحقيق هذا الفعل للإتيان بمقدّمته التي توقف عليها.
فمثلا: لو أمر صاحب المزرعة عمّالها بحرثها، وهم يدركون أنّ الحرث يتطلّب إستعمال آلاته، سوف يحضرونها ويستعملونها ولو لم يأمرهم صاحب المزرعة بذلك.
وهكذا لو قال الطبيب للمريض: استعمل هذا الدواء المكتوب في هذه الوصفة لمدّة اسبوع، فإنّ المريض يدرك أنّ عليه أن يذهب إلى الصيدلية لأخذ الدواء منها وان لم يأمره الطبيب بذلك.
ومنه نخلص إلى أنّ المراد بالملازمة - في العرف الإجتماعي -:
استلزام شيء ثبت بالأمر به أو النهي عنه أو الإرشاد إليه بالفعل أو الترك، لما يتوقف تحقّقه عليه عقلا أو تجربة.
وفي ضوئه يمكننا أن نعرّف الملازمة في العرف الشرعي بأنّها: الترابط بين حكم شرعي ثبت بالنصّ وحكم شرعي آخر كشف عنه العقل.
وهذا نحو الأمر بالوضوء بنصّ شرعي المستلزم لذهاب المكلّف إلى محلّ الماء واستعماله، فإن العقل هنا يدرك - وببداهة - وجوب ذهاب المكلّف الى محل الماء لأجل التوضوء منه، وأنّه مطلوب شرعا وان لم ينصّ الشارع على ذلك.
وإعتمادا على هذه البداهة الموجودة عند كلّ إنسان بما يعطي صفة الإجتماعيّة العامّة للظاهرة لم يصدر المشرّع نصّا بحكم أمثال هذه المستلزمات، أي انّه اعتمد في معرفة حكمها على المكلّف لأنّه يدركها بعقله وببداهة.
وما دامت المسألة بهذا اليسر من التصوّر والتصوير لا نحتاج إلى أن ندخلها مجالات الفلسفة أو الكلام، ونطيل البحث بما لا ضرورة تدعو إليه.
وكما رأينا، إنّ الملازمة ليست بين حكم شرعي وآخر عقلي، وإنّما هي قائمة بين حكمين شرعيين: أحدهما نصّ عليه الشرع، وآخر ترك أمر معرفته وإدراكه لبديهة عقل المكلّف.
الهوامش:
(1)- 1/ 206.
(2)- 1/ 191.
(3)- صحاح المرعشليين: مادة: لزم.