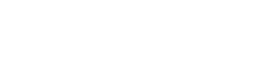محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 32
وتفصيل القول فيها كالتالي:
- وجه السريان في الشبهة المفهومية في الموضوع الأوّل والموضوع الثاني يرجع إلى أنّ العام مع الخاص المتّصل لا ينعقد له ظهور في العموم، بسبب إجمال الخاص لأنّه قرينة، وإجمال القرينة يسري إلى ذي القرينة في نظر العرف، وإذا لم ينعقد له ظهور لا يكون حجّة.
- ووجه عدم السريان في الشبهة المفهوميّة في الموضوع الثالث هو لأنّ العامّ مع المخصّص المنفصل ينعقد له ظهور في العموم، ومع ظهوره يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العامّ.
- ووجه السريان في الشبهة المفهوميّة في الموضوع الرابع هو حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا، المردّد بين شيئين، فيسقط العامّ عن الحجّة في كلّ واحد منهما.
- أمّا في الشبهة المصداقيّة في الصورتين الأوّليين فوجّه سريان الإجمال من الخاص إلى العام هو السبب نفسه في الشبهة المفهوميّة، وهو عدم إنعقاد ظهور للعامّ في العموم.
- وفي الصورة الأخيرة فللعلم الإجمالي بالتخصيص.
- وتبقى الصورة الثالثة موضع الخلاف:
فقد ذهب أكثر المتقدّمين من علمائنا إلى القول بعدم سريان إجمال الخاص إلى العامّ، ومن ثمّ جوّزوا التمسّك بالعامّ لإدخال الفرد المشكوك في حكم العامّ.
واستفاد الباحثون الاُصوليون هذا من فتوى المتقدّمين في اليد المشكوكة - هل هي يد عادية أو يد أمينة - بأنّها ضامنة، أي انّها عادية.
وذلك بتقريب أنّ قوله(صلىالله عليه وآله وسلم): (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي) شامل لليد الأمينة والاُخرى العادية، إلا أنّه خصّص بما دلّ على أنّ اليد الأمينة لا ضمان عليها.
ولازم هذا أنّ فتواهم جاءت نتيجة اجرائهم لأصالة العموم، التي أثبتت لهم انّ اليد المشكوكة هل هي أمينة أو عادية أنّها يد عادية وعليها الضمان.
وذهب المتأخّرون ومتأخّروهم والمعاصرون إلى عدم جواز التمسّك بالعام في هذه الصورة أيضا.
وهذا يسلّمنا إلى أنّ إجمال الخاص في الشبهة المصداقية - على رأيهم - يسري إلى إجمال العامّ فلا يجوز التمسّك به.
قال الملا الآخوند في (الكفاية)(1) -: وأمّا إذا كان (الخاص) مجملا بحسب المصداق، بأن اشتبه فرد وتردّد بين أن يكون فردا له (أي للخاص) أو باقيا تحت العام:
- فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعام لو كان متّصلا به، ضرورة عدم إنعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص - كما عرفت -.
- وأمّا إذا كان منفصلا عنه، ففي جواز التمسّك به خلاف، والتحقيق عدم جوازه، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: إنّ الخاص إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلا حجّة، ولا يكون حجّة فيما اشتبه انّه من أفراده، فخطاب (لاتكرم فسّاق العلماء) لايكون دليلا على حرمة إكرام من شكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثل: (اكرم العلماء) ولا يعارضه، فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة، وهو في غاية الفساد، فانّ الخاص وان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، إلا أنّه يوجب اختصاص حجيّة العامّ في غير عنوانه من الأفراد، فيكون (أكرم العلماء) دليلا وحجّة في العالم غير الفاسق، فالمصداق المشتبه وان كان مصداقا للعامّ بلا كلام، إلا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة لإختصاص حجيّته بغير الفاسق.
وبالجملة: العامّ المخصّص بالمنفصل، وان كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصّصا، بخلاف المخصّص المتّصل - كما عرفت -، إلا أنّه في عدم الحجيّة إلا في غير عنوان الخاص مثله، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الإندراج تحت إحدى الحجتّين، فلابدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.
(التطبيق):
ويثمر الخلاف في المسألة بتطبيق أصالة العموم على القول بعدم سريان الإجمال من الخاص إلى العامّ.. وعدم صحّة جريانها على القول بسريان الإجمال.
المخصّص اللّبي:
كان حديثنا المتقدّم في مسألة إجمال الخاصّ عن الخاصّ اللفظي.
وهنا: ألحق الاُصوليون به منذ عهد الشيخ الأنصاري ما أطلقوا عليه عنوان (المخصّص اللّبي) نسبةً إلى اللّب الذي هو العقل، إلا أنّهم أرداوا به ما يعمّ الدليل غير اللفظي، وهو الإجاع ودليل العقل.
وفي مطاوي البحث فرّقوا بين الإدراك العقلي الضروري والإدراك العقلي النظري - كما سيأتي.
كما انّهم حدّدوا مجال البحث في إجمال المخصّص اللّبي في الشبهة المصداقيّة.
وفي المسألة ثلاثة أقوال، هي:
1- قول الشيخ الأنصاري في (التقريرات):
قال اُستاذنا الشيخ المظفّر في (الاُصول)(2): نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاري(قدس سره) جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة مطلقا إذا كان المخصّص لبيّا، وتبعه جماعة من المتأخرين عنه.
وقال السيّد يوسف مكّي العاملي في (القواعد)(3): قيل بالجواز مطلقا أي كان هذا المخصّص اللّبي كاللفظي المتّصل أو كالمنفصل، ونسب هذا القول إلى شيخنا المرتضى الأنصاري(قدس سره) في تقريراته.
2- قول الملّا الآخوند في (الكفاية):
وهو قول بالتفصيل:
- بيّن ما إذا كان المخصّص اللّبي ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب بأن يكون عرفا من القرائن المتّصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص، وذلك كما لو كان عقليّا ضروريّا، فهو - هنا - كالمتّصل، لا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ فيه لإثبات حكم الفرد المشكوك، لعدم إنعقاد ظهور للعامّ إلا في الخصوص.
- وبيّن ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا لم يكن التخصيص ضروريّا على وجه يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم، فالظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبه على حجيّته كظهوره فيه، فكما انّ ظهور العامّ في حكم الفرد ثابت كذلك حجيّته، فيصحّ الأخذ به لإثبات حكم الفرد(4).
ولخّص شيخنا المظفّر(دليل صاحب الكفاية على صحّة قوله المذكور في أعلاه بقوله(5) -: واستشهد (يعني صاحب الكفاية) على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء، كما إذا أمر المولى منهم عبده بإكرام جيرانه، وحصل القطع للعبد بأنّ المولى لا يريد إكرام من كان عدوّا له من الجيران، فإنّ العبد ليس له أن لا يكرم من يشكّ في عداوته، وللمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه ولا يصحّ منه الإعتذار بمجرد إحتمال العداوة، لأنّ بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجيّة أصالة الظهور، فيكون ظهور العامّ - في هذا المقام - حجّة بمقتضى بناء العقلاء.
3- قول الميرزا النائيني:
وخلاصته - كما في اُصول شيخنا المظفّر(6) -: انّ المخصّص اللّبي سواء كان عقليّا ضروريا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في مقام التخاطب، أو لم يكن كذلك، بأن كان عقليّا نظريا أو إجماعا، فإنّه كالمخصّص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العامّ، فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللّبي واللفظي، لأنّ المانع من التمسّك بالعام مشترك بينهما، وهو إنكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا، ولا يفرّق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيّا أو لبّيا.
هذه خلاصة ما جاء في هذه المسألة عرضا واستدلالا ونقدا.
المطلق والمقيّد
أهميّتهما:
لا يختلف المطلق والمقيّد عن العامّ والخاص في أنّهما من الظواهر اللغوية الاجتماعية العامّة، الشائعة في جميع اللغات وكلّ المجتمعات.
كذلك هما من القضايا العلميّة المنتشرة في جلّ بل كلّ موضوعات الفقه، فَقَلَّ أن ترى موضوعا فقهيّا خاليا من الإطلاق والتقييد.
تصنيفهما:
ولهذه الأهميّة التي يتمتّعان بها اهتمّ اللغويون من عرب وغير عرب بتعريفهما وبحثهما وتتبّع مفرداتهما اللغوية الإجتماعية، كما عني بهما الاُصوليون ومع بدايات بحوثهم الاُصوليّة الرائدة.
غير فارق واحد - من ناحية منهجيّة - لمسناه في البحث الاُصولي لهما بين أكثر الأقدمين ومتأخّريهم من جانب وأكثر متأخّري المتأخّرين والمعاصرين من جانب آخر.
وهو أن رأينا أمثال العلّامة الحلّي في (مبادئ الوصول) والوحيد البهبهاني في (الفوائد الحائرية) يبحثانهما تحت عنوان (حمل المطلق على المقيّد) وبشكل مختصر.
ففي (مبادئ العلامة) عقد لهما البحث التاسع - وهو الأخير - من بحوث العامّ والخاص.
ومن قبله رأينا الشريف المرتضى في كتابه الاُصولي الرائد (الذريعة) يعقد لهما فصلا من فصول العامّ والخاص يسبقه (فصل في تخصيص العموم بالشرط) ويتبعه (فصل في ذكر مخصّصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم).
أمّا الحال عند أكثر متأخّري المتأخّرين والمعاصرين فبالعكس فقد أفردوهما بالبحث بعد بحث العامّ والخاص، إلا أنّ بعضهم جمع بينهما وبين المجمل والمبيّن في باب واحد، وبعضهم فرّق بينهما فعقد لكلّ واحد منهما بابا مستقلا به.
فمثلا في (كفاية الآخوند) يخصّص المقصد الرابع للعامّ والخاص، ويجعل المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن، وفي (اُصول مغنية) يعقد للمطلق والمقيّد بابا مستقلا بعد باب العام والخاص، ويعقد للمجمل والمبيّن بابا مستقلا بعد باب المطلق والمقيّد.
وعلى هذا سار التبويب الاُصولي في سائر كتب المعاصرين باستثناء أمثال كتاب (دروس في علم الاُصول) لاُستاذنا الشهيد الصدر حيث جمع بين الإطلاق والعموم في فصل واحد، وكتاب (المحكم) للسيّد محمّد سعيد الحكيم الذي رجع في تبويبه إلى ما نهجه المتقدّمون من إدراج الإطلاق والتقييد ضمن موضوع العموم والخصوص.
ويرجع سبب هذه التفرقة في التبويب إلى ما اُثير حول تحديد كيفيّة دلالة المطلق على الشمول هل هي في جميع مفرداته بدليل العقل (مقدّمات الحكمة)، أو انّ بعضها كذلك والاُخرى بالوضع.
ومحور الخلاف في المسألة الذي وقع فيه البحث هو انّ الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها:
- هل هو بالوضع.
- أو بمقدّمات الحكمة؟
أي أنّ أسماء الأجناس:
- هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ - كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء -.
- أو أنّها موضوعة لنفس المعاني بما هي، والإطلاق يستفاد من دالّ آخر، وهو نفس تجرّد اللفظ من القيد إذا كانت مقدّمات الحكمة متوفّرة فيه؟
وهذا القول الثاني أوّل ما صرّح به - فيما نعلم - سلطان العلماء في حاشيته على (معالم الاُصول)، وتبعه جميع من تأخّر عنه إلى يومنا هذا(7).
والأثر المترتّب على هذا الخلاف هو:
- على القول الأوّل (رأي المشهور) يكون استعمال اللفظ في المطلق على الحقيقة، وفي المقيّد على المجاز.
- وعلى القول الثاني (رأي سلطان العلماء) يكون استعمال اللفظ في المطلق والمقيّد على الحقيقة.
وسيأتي بيان ما يترتّب على هذا أيضا.
ولأنّ هذه المسألة من المسائل الخلافيّة تأثّر تصنيفها في مجال التبويب برأي الباحث الاُصولي:
- فإن كان رأيه أنّ دلالة المطلق على الشيوع هي بالوضع أدرج موضوع المطلق والمقيّد في مبحث العام والخاص، وان كان رأيه أنّ الدلالة بالقرينة (مقدّمات الحكمة) فصّلهما وأفردهما ببحث خاصّ بهما.
ونحن - هنا - نفردها تبعا لأكثر المعاصرين بهذا المبحث المستقلّ، وفي طواياه سوف نعرّف أي الرأيين هو الراجح.
الهوامش:
(1)- ص 221-222.
(2)- 1/ ص 135.
(3)- ص 284.
(4)- وراجع: حقائق الأصول 1/ 499- 500 وأصول المظفر 1/ 135.
(5)- 1/ ص 135- 136.
(6)- 1/ ص 136.
(7)- أصول المظفر 1/ 152.