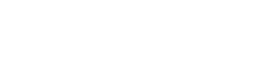محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 30 - العامّ بعد التخصيص
العامّ بعد التخصيص:
نتناول هنا مسألتين مترابطتين بترتّب الثانية على الاُولى تحت عنوان واحد وهو هذا العنوان، وذلك لأجل هذا الترابط القائم بينهما، وان كان الاُصوليون من حيث التصنيف تناولوا كلّ واحدة منهما مستقلّة عن الاُخرى، وهما:
المسألة الاُولى:
- هل العامّ بعد التخصيص يبقى دالا دلالة حقيقية على الإفراد التي لم يشملها التخصيص، وهي ما عبّروا عنها بـ(الإفراد الباقيّة) أو (الباقي)، فيكون استعماله فيها استعمالا حقيقيّا؟
- أو أنّه لم تبق له دلالته الحقيقيّة التي كانت له قبل التخصيص لأنّها تحوّلت بعد التخصيص إلى دلالة مجازية؟
المسألة الثانية:
هل للعام بعد التخصيص ظهور في الباقي فيكون حجّة فيه؟
أو أنّه لم يبق له ظهور فيه فلا يكون حجّة فيه؟
ولابدّ قبل البحث في هاتين المسألتين من التمهيد، فنقول: إنّ ألفاظ الأسماء في اللغات، مثل لفظ (رجل) و (امرأة) و (عالم) و (مهندس) و (فلاح)، قبل استعمالها ضمن التركيبات اللفظيّة - جملا أو غيرها - لا دلالة فيها على بعض أو كل، وإنّما تدلّ على مطلق معناها، ولكن فيها صلاحية على الدلالة على البعض والدلالة على الكل، متى اقترنت بما يفيد ذلك.
فمثلا: لفظ (رجل):
- إذا قلت (هذا رجل) دلّ على فرد خاص - وهو المشار إليه - بسبب اقترانه باسم الإشارة.
- وإذا قلت: (كلّ رجل في بيتنا هو مسلم) دلّ على العموم الشامل لكلّ أفراده بسبب اقترانه بأداة العموم التي هي (كل).
وهو - أعني لفظ رجل - في كلتا الدلالتين (الخصوص والعموم) حقيقة ولكن تخصيص الدلالة وتعميمها ليس من حاقه، وإنّما هو وظيفة ما يقترن به.
وهو - أيضا - في كلتا الدلالتين (الخصوص والعموم) له ظهور في الدلالة على الخصوص أو العموم، وأيضا بواسطة ما اقترن به.
- ولكن إذا قلنا: (كل رجل في قريتنا يجب أن يحترم إلا المنافق)، قد يتساءل: هل بقيت كلمة (رجل) على شمولها لكلّ رجل في القرية أو أنّها ضاقت دائرة شموليتها لأنّه اُريد بها ما عدا المنافقين.
فإن بقيت على شموليتها وعمومها للجميع فهي حقيقة في الرأي الاُصولي لأنّها - في رأيهم - موضوعة للعموم، وقد استعملت فيما وضعت له، ولها ظهور في العموم، فيكون استعمالها في الأفراد الباقية بعد التخصيص استعمالا حقيقيّا، ويكون ظهورها فيها حجّة يؤخذ به ويعمل على وفقه.
وإن لم تبق الشموليّة فالأمر بالعكس، أي يكون الاستعمال مجازيا، لأنّها استعملت في البعض وهو غير ما وضعت له، ولا ظهور لها في العموم، ومن ثم لا تكون حجّة.
وقد تكثّرت الأقوال في المسألة تكثّرا لافتا للنظر، وقد أتى على كلّها أو جلّها بالذكر والعرض الميرزا القمّي في (القوانين).
وذكر شيخنا المظفّر في (الاُصول) أهمّها، وهي:
1- القول بالحقيقة والحجيّة مطلقا.
2- القول بالعدم مطلقا.
3- القول بالتفصيل بين المخصّص المتّصل فإنّ العام معه حقيقة في الباقي وحجّة فيه، والمخصّص المنفصل فإنّه بالعكس.
وفي هدي ما ذكرناه في التمهيد من انّ العموم والخصوص لم يستفد من لفظ العامّ أو لفظ الخاص لأنّهما لا دلالة فيهما على ذلك، وإنّما فيهما الصلاحيّة للدلالة على ذلك متى اقترنا بما يفيد ذلك، وإنّما استفيد (أعني العموم أو الخصوص) ممّا اقترنا به.
فـ(كلّ) - أداة العموم - تعطي العموم لما تدخل عليه، وهي في حالة التخصيص داخلة على لفظ العامّ المقتصر في حكمه على ما عدا الخاص، فعمومه فيما شمله حكمه هو الأفراد الباقية بعد التخصيص.
وعلى هذا هو حقيقة في هذا الباقي بعد التخصيص كما كان حقيقة في جميع الأفراد قبل التخصيص.
ومتى كان حقيقة كان له ظهور، وإذا كان له ظهور كان حجّة. وإثبات الظهور للعامّ في الباقي وتقديره قضيّة عرفيّة.
قال الميرزا القمّي في (القوانين) - في معرض إستدلاله لإثبات ظهور العامّ في الباقي - لنا: ظهوره في إرادة الباقي بحيث لا يتوقّف أهل العرف في فهم ذلك حتّى ينصب قرينة اُخرى عليه غير المخصّص، ولذلك ترى العقلاء يذمّون عبدا قال له المولى: (اكرم من دخل داري)، ثمّ قال: (لا تكرم زيدا) إذا ترك إكرام غير زيد أيضا.
وصريح علمائنا الإماميّة في انّه لا خلاف بينهم في ظهور العامّ وحجيّته في الباقي.
يقول القمّي في (القوانين): (وأمّا المخصّص المبيّن فالمعروف من مذهب أصحابنا: الحجيّة في الباقي مطلقا.
ونقل بعض الأصحاب اتّفاقهم على ذلك.
وقال الشيخ الأنصاري في (التقريرات): لا ينبغي الإشكال في أنّ العام حجّة في الباقي.. ولا يظهر من أصحابنا الشيعة فيه خلاف، وإنّما نسب الخلاف إلى بعض السنّة(1).
وقال الملا الآخوند في (الكفاية):لا شبهة في أنّ العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي، ممّا علم عدم دخوله في المخصّص مطلقا ولو كان متّصلا، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا، كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف وهو - بعبارته الأخيرة - يشير إلى ما أشار إليه قبله اُستاذه الشيخ الأنصاري من انّ الخلاف في المسألة لم يعرف إلا عند بعض علماء أهل السنّة.
ومن تطبيقات ظهور العامّ في الباقي والاعتماد عليه باعتباره حجّة ما مثّل به شيخنا المظفّر من أنّه إذا قال المولى: (كلّ ماء طاهر) ثمّ استثنى من العموم بدليل متّصل أو منفصل الماء المتغيّر بالنجاسة، ونحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيير، فإذا قلنا بأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي تطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العامّ في جميع الباقي فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغيّر.. وإذا لم نقل بحجيّته في الباقي يبقى هذا الاحتمال معلّقا لا دليل عليه من العامّ، فلنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو بنجاسته(2).
العمل بالعامّ قبل الفحص:
عنوان المسألة كاملا هو (مشروعيّة العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص).
وينطلق إلى دراسة هذه المسألة من منطلقين:
- من منطلق أنّها ظاهرة عرفيّة عامّة يتعامل معها الناس في تبادلهم شؤون حياتهم وقضاياها.
- من منطلق أنّها ظاهرة شرعيّة خاصّة يتعامل معها الفقهاء المجتهدون بهدف الوصول إلى الحكم الشرعي.
ولابدّ - هنا - من التمييز بين هذين المنطلقين لنفيد من هذا التمييز منهجيّا، ذلك أنّنا في دراستنا لموضوع علم اُصول الفقه في مدخل الكتاب قلنا: إنّ هذا العلم يدرس الظواهر اللغوية - الاجتماعيّة والاُخرى الإجتماعيّة - الإجتماعيّة.
وفي مجال دراسة الظاهرة اللغوية - الإجتماعيّة قلنا: إنّه يدرس ظاهرة الظهور المتمثّلة في أصالة الحقيقة وأصالة العموم وسواهما.
ومتى تنقّح لدينا ظهور لفظ ما أخذنا به لأنّ سيرة الناس (العقلاء) في جميع المجتمعات على هذا.
ثمّ منه ننطلق إلى تطبيق هذا على الألفاظ المستعملة على لسان الشارع المقدّس، لأنّه لم ينفرد بطريقة خاصّة يختلف بها عن سيرة الناس وطريقتهم في العمل والأخذ بظهورات الألفاظ.
أمّا هنا - أعني في مسألتنا هذه - فالأمر مختلف تماما، وذلك لأنّ الاُصوليين من خلال استقرائهم للنصوص الشرعيّة اكتشفوا أنّ للشارع المقدّس طريقته المتميّزة في تخصيص العمومات، وهي أنّ أكثر العمومات الشرعيّة تخصّص بمخصّصات منفصلة.
ولهذا قال المحقّقون منهم: لا يجوز الأخذ بالعموم إلا بعد الفحص واليأس من وجود المخصّص ليتحقّق الباحث من ظهور العامّ في العموم الشامل ليأخذ به.
فهنا - أعني في العمومات الشرعيّة - لا نستطيع أن نتمسّك بأصالة الظهور المتمثّلة هنا بأصالة العموم، فنحمل العام على عمومه وشموله لجميع أفراده، للسبب المذكور.
أمّا في العمومات العرفيّة فالأمر على العكس حيث لم يكن من طريقتهم تأخير المخصّص، فباستطاعتنا التمسّك بأصالة العموم وحمل العامّ على عمومه.
وقد ألمح إلى هذا خريت هذا العلم الشيخ الأنصاري في (التقريرات) بقوله: لم يظهر من العرف توقّف عن العمل بمداليل الألفاظ قبل الفحص، بل ذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار(3).
فإذن، لابدّ في العمومات الشرعيّة من الفحص عن مخصّصاتها، وبعد اليأس من وجودها يصحّ العمل بالعام.
وقد اختلفت كلمتهم في تحديد موضع الخلاف (محور البحث في المسألة):
- هل هو البحث عن مشروعية العمل بالعامّ قبل الفحص.
- أو هو في تحديد مقدار الفحص عن المخصّص لأنّ العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص مفروغ من عدم مشروعيّته.
قال العاملي في (المعالم)(4):ذهب العلامة(رحمه الله) في (التهذيب) إلى جواز الإستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص، واستقرب في (النهاية) عدم الجواز ما لم يستقصِ في طلب التخصيص وحكى فيها كلا من القولين عن بعض العامّة.
وقد اختلف كلامهم في بيان موضع النزاع:
- فقال بعضهم: إنّ النزاع في جواز التمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص، وهو الذي يلوح من كلام العلّامة في (التهذيب)، وصرّح به في (النهاية).
- وأنكر ذلك جمع من المحقّقين قائلين: إنّ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص ممتنع إجماعا، وإنّما الخلاف في مبلغ البحث:
- فقال الأكثر يكفي بحيث يغلب معه الظنّ بعدم المخصّص.
- وقال بعض: إنّه لا يكفي ذلك، بل لابدّ من القطع بانتفائه.
وأخيرا: تسالمت كلمة القوم على وجوب الفحص حتّى اليأس، إلا أنّهم اشترطوا لوجوب الفحص صلاحية العامّ للتخصيص، ذلك أنّه في حالة عدم صلوحه للتخصيص، كما في قوله تعالى: (لا يستوي الخبيث والطيّب) لا معنى لوجوب الفحص.
أمّا متى يحصل اليأس؟، فكما يقول شيخنا المظفّر (الاُصول)(5): إنّ الذي يهوّن الخطب في هذه العصور المتأخّرة أنّ علماءنا - قدّس اللَّه تعالى أرواحهم - قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتّى أنّ الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانّها المهيأة، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها.
مشروعيّة العمل بالخاص:
استند الاُصوليون في إثبات حجيّة الخاصّ ومشروعيّة العمل به إلى أنّه قرينة ينصبها المتكلّم ليدلّ بها على إرادة ما عدا الخاص من العموم.
واستندوا في حجيّة القرينة إلى بناء العقلاء القائم على اعتماد القرينة في تعيين وتشخيص مرادات المتكلّمين، وما ذلك إلا أنّ الخاص له ظهور في الخصوص، والظهور - كما تقدّم - حجّة يؤخذ به ويعمل على وفقه.
وينبطق هذا على كلّ من قسمي الخاص: المتصل والمنفصل. هذا من الناحية العمليّة.
أمّا من الناحية العلميّة فيفرّق الاُصوليون بين دلالة العامّ مع المخصّص المتّصل ودلالته مع المنفصل.
- فإنّه مع الخاص المتّصل لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا ما استثناه الخاص من أفراده.
وبهذا يكون الكلام من البداية ظاهرا في الخصوص.
- وبعكسه مع الخاص المنفصل فإنّه ينعقد للعامّ ظهور في العموم، ولكن ظهور الخاص لأنّه قرينة أقوى من ظهور العامّ، وذلك لأنّ الخاص إمّا نصّ في معناه أو أظهر في دلالته على معناه من دلالة العامّ على معناه.
فيقدّم الخاص على العام من باب تقديم أقوى الحجتين، أو قل: من باب تقديم النصّ على الظاهر، أو تقديم الأظهر على الظاهر.
الهوامش:
(1)- عن علم اُصول الفقه للشيخ مغنية 170.
(2)- اُصول الفقه1/130.
(3)- عن كتاب(علم اُصول الفقه) للشيخ مغنية 182.
(4)- 282- 283.
(5)- 1/ 140.