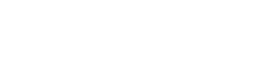محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 27
- وقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).
فـ(المتبادر دون الشرط أنّ الأزواج لهم نصف ما تركت زوجاتهم في جميع الأحوال، ولكن قوله تعالى (إن لم يكن) لهنّ ولد) شرط خصّص العموم، أي يستحقّ الأزواج نصف الميراث في حالة واحدة وهي ان لم تترك الزوجة ولدا(1).
وقوله تعالى: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف).
أي إذا أردتم أيّها الآباء أن تعيّنوا لأولادكم مراضع غير الاُمّهات فلا مانع من ذلك إذا آتيتموهنّ اُجرتهنّ بالمعروف عن طيب نفس.
فلفظ (الجناح) - وهو الإثم - عام لأنّه نكرة في سياق النفي، ولكن هذا النفي مشروط بشرط وهو تسليمهنّ اُجرتهنّ بالمعروف، فلا إثم عليكم في حالة واحدة، وهي تسليم الأجر، فجاء الشرط هنا مخصّصا للفظ العامّ(2).
(الصفة):
(ومن أمثلة تخصيص العامّ بالصفة:
- قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلّمة إلى أهله).
فـ(رقبة) لفظ عامّ خصّص بالصفة وهي (مؤمنة).
- وقوله تعالى: (حرّمت عليكم اُمّهاتكم... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ).
فالربائب والنساء لفظان عامّان خصّص كلّ منهما بالوصف التالي له.
- وقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصّنات المؤمنات فمّما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات).
انّ لفظ (فتيات) عامّ قد خصّص بصفة وهي (المؤمنات)...
فالصفة في التخصيص تجري مجرى الاستثناء والشرط في الإخراج من حكم العام.
(الغاية):
يقول السيّد المرتضى: والغاية تجري في المعنى (يعني التخصيص) مجرى الشرط، وقوله تعالى: (ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن) معناه (إلا أن يطهرن)، فإن طهرن فأقربوهنّ.
وكذلك قوله تعالى: (حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون)....
ومن أمثلته أيضا:
- قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).
(البدل):
ويريدون به (بدل البعض من الكلّ)، ومثّلوا له بقوله تعالى: (وللَّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا)، فقد خصّص البدل المذكور في الآية الكريمة وهو قوله (من استطاع) عموم لفظ (الناس).
وجريانه في التخصيص جريان سوابقه.
وفي النهاية لابدّ من القول بأنّ ما ذكره الاُصوليون من أساليب التخصيص في اللغة العربية (الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل) هي الأساليب المعقّدة.
أمّا من حيث مطلق التعبير فأي كلام يشتمل على ما يفيد العموم وما يفيد الإخراج من حكم ذلك العموم يعتدّ - اُصوليّا - كلاما مخصّصا ويدخل في دائرة التخصيص.
وهذا مثل ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: (كلُّ مَن عليها فان × ويبقى وجه ربِّك ذو الجلال والإكرام).
فلفظ (كل) - في الآية الكريمة - عام، وجملة (يبقى) خاصّ لأنّه إخراج من حكم ذلك العامّ وهو الفناء، فانّك تستطيع أن تقول: (كلّ من عليها فانٍ إلا وجه ربّك)، والمعنى المقصود - كما هو - لم يتغيّر، وهو انّ حكم الفناء شامل لكلّ من عليها إلا الذات المقدّسة فانّها لا تفنى.
مصادر التخصيص:
أشرت في أوّل موضوعنا هذا (العام والخاص) إلى أنّ ظاهرتي التعميم والتخصيص هما من الظواهر اللغوية الاجتماعية العامّة، التي شملت لغات البشر على اختلاف مجتمعاتهم لارتباطها بطبيعة حياتهم الاجتماعية على تنوّع شؤونها فكريّة وغير فكريّة.
ثمّ قمت بتعريف ألفاظ العموم في اللغة العربية التماسا لوجود الظاهرة في لغتنا، ولأنّنا نتعامل في فقهنا مع النصوص الشرعيّة من آيات وأحاديث ومأثورات - وهي بلساننا العربي المبين - منطلقين إلى ذلك من معطيّات اُصول الفقه.
ومن بعد ذلك قمت بتعريف أساليب التخصيص في اللغة العربية بغية معرفة نصوص التخصيص الشرعيّة من خلال تطبيقات هذه الأساليب.
والآن جاء دور محاولة تعرّفنا مصدر المدد الفكري الذي تستقي منه مادّة التخصيص الشرعيّة من خلال استقراء الاُصوليين للشرعيّات لمعرفة أنّ العامّ المخصّص الذي نريد استنباط الحكم الشرعي منه هو من الشرعيّات وانّه مأخوذ من دليل شرعي يحتجّ به، ويستنبط منه.
ومن هنا عنون الاُصوليون هذه المسألة بعنوان (أدلّة التخصيص) لأنّها ترجع إلى أدلّة الفقه: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وهي - في الوقت نفسه - تسمّى مصادر الفقه.
والمقصود من بحث هذه المسألة معرفة أنّ مادّة التخصيص شرعيّة ليصحّ لنا التعامل معها في مجال الاستنباط.
وتبيّنا انّ المراد بالمصادر - هنا - هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.
وذكر الشيخ المفيد منها ثلاثة: القرآن والسنّة الثابتة (القطعيّة) والعقل، قال في مختصره(3): وليس يخصّ العموم إلا دليل العقل والقرآن والسنّة الثابتة.
فأمّا القياس والرأي (يعني إجتهاد الرأي)، فإنّهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما، ولا يخصّان عامّا، ولا يعمّمان خاصّا، ولا يدلّان على حقيقة.
ولا يجوز تخصيص العامّ بخبر الواحد، لأنّه لا يوجب علما، ولا عملا، وإنّما يخصّه من الأخبار ما انقطع العذر لصحّته عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أحد الأئمّة.
وفي (الذريعة): نوّع المرتضى أدلّة التخصيص إلى:
1- عقليّة.
2- وسمعيّة.
وقسّم السمعيّة إلى:
أ- ما يفيد العلم.
ب- وما يفيد الظنّ.
قال: فأمّا المخصّص فقد يكون دليلا عقليّا وقد يكون سمعيّا. والسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظنّ كالقياس وأخبار الآحاد.
وليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصّصات.
ثمّ فصّلها بقوله: اعلم أنّ تخصيص العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها وإجماع.
ولا شبهة فيه ولا خلاف من محقّق في مثله لأنّ القاطع إذا دلّ على ضدّ حكم العامّ، ولم يجز تناقض الأدلّة، فلابدّ من سلامة الدليلين، ولا يسلمان إلا بتخصيص ظاهر العموم.
ثمّ أعطى القاعدة العامّة فقال: وجملة القول في هذا الباب: انّ كلّ شيء هو حجّة في نفسه لابدّ من تخصيص العموم به.
(القرآن):
أ- تخصيص القرآن بالقرآن:
لا خلاف في وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب، ومشروعيّة الإحتجاج به والإستناد إليه.
قال المحقّق الحلّي في (المعارج)(4): تخصيص الكتاب بالكتاب جائز، كقوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) ثمّ قال (تعالى) في موضوع آخر: (حتّى يعطوا الجزية عن يد)....
وقال العلّامة الحلّي في (المباديء)(5): تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو جائز خلافا للظاهرية - كقوله تعالى (والمطلّقات يتربصنّ بأنفسهنّ ثلاثة قروء) مع قوله: (واُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ)....
ومن أمثلته أيضا: قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)، فإنّه عامّ يشمل بحكمه وهو الجلد جميع الذين يقذفون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، ولكنّه خصّص بقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللَّه...)، وهو مثال للخاصّ المنفصل.
ومثال الخاص المتّصل: قوله تعالى: (إنّ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا...)، فلفظ (الإنسان) عامّ شامل بحكمه وهو (الخسران) جميع أفراده، ولكنّه خصّص بقوله تعالى: (إلا الذين آمنوا).
ب- تخصيص القرآن بالسنّة القطعيّة:
يريدون بالسنّة القطعيّة - هنا - الحديث المتواتر، والحديث المقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.
وكذلك لا خلاف بينهم في جواز تخصّص الكتاب بالسنّة القطعيّة وصحّة الإحتجاج به.
قال السيّد المرتضى في (الذريعة): وأمّا تخصيص الكتاب بالسنّة (يعني بها القطعيّة) فلا خلاف فيه (يعني بين أصحابنا الإماميّة)، وقد وقع كثير منه، لأنّه تعالى قال: (يوصيكم اللَّه في أولادكم للذكر مثل حظّ الاُنثيين)، وخصّص عموم هذا الظاهر قوله(عليه السلام): (لا يرث القاتل) و (لا يتوارث أهل ملّتين)....
وفي (المعارج)(6) يقول المحقّق: وكذلك تخصيص الكتاب بالسنّة (أي انّه جائز):
قولا، كتخصّص آية المواريث (يوصيكم اللَّه في أولادكم..) بقوله(عليه السلام): (القاتل لا يرث).
وفعلا، كتخصيص آية الجلد (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة) برجمه(صلى الله عليه وآله وسلم) ماعزا(7).
وفي (المباديء) يقول العلّامة: تخصيصه (يعني الكتاب) بالسنّة المتواترة جائز - خلافا لبعض الشافعيّة - لقوله (عليه السلام): (القاتل لا يرث) في تخصيص قوله تعالى: (يوصيكم اللَّه في أولادكم)، وكتخصيص آية الجلد برجم المحصن.
ج- تخصيص القرآن بخبر الواحد:
وهي من المسائل الخلافيّة بين الاُصوليين وبخاصة القدامى منهم. وفي تعداد أقوال الاُصوليين من أهل السنّة في هذه المسألة يقول الآمدي في (الأحكام)(8) يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنّة.
أمّا إذا كانت السنّة متواترة فلم أعرف فيه خلافا.
وأمّا إذا كانت السنّة من أخبار الآحاد:
- فمذهب الأئمّة الأربعة جوازه.
- ومن الناس من منع ذلك مطلقا.
- ومنه من فصّل، وهؤلاء اختلفوا:
فذهب عيسى بن أبان إلى أنّه إن كان قد خصّ بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا.
وذهب الكرخي إلى انّه إن كان قد خصّ بدليل منفصل لا متّصل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا.
- وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف.
والتعداد نفسه نجده في (القوانين) ولكن بعرض مختصر، ففيه: لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، ولا بالإجماع، ولا بالخبر المتواتر، ووجهها ظاهر (وهو ثبوت وقطعيّة الصدور عن المعصوم).
واختلفوا في جوازه بخبر الواحد على أقوال:
- ثالثها: التفصيل، فيجوز إن خصّ قبله بدليل قطعي.
- ورابعها: التفصيل أيضا بتخصيصه بما خصّ قبل بمنفصل قطعيّا كان أو ظنيّا.
- وخامسها: التوقف.
ثمّ قال مؤلّفه: والأظهر الجواز كما هو مذهب أكثر المحقّقين.
والقولان الأوّلان اللذان لم يذكرهما لأنّهما يفهمان من التفصيل، هما: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا.
وهذه الأقوال الخمسة في مسألتنا هذه هي أقوال الاُصوليين من أهل السنّة كما أبان عن ذلك بيان الآمدي المذكور في أعلاه.
أمّا عند أصحابنا الإماميّة فهي قولان: المنع والجواز.
يقول العاملي في (المعالم)(9): لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر.
وأمّا تخصيصه بخبر الواحد - على تقدير العمل به - فالأقرب جوازه مطلقا.
وبه قال العلّامة وجمع من العامّة (يعني أهل السنّة). وحكى المحقّق(رحمه الله) عن الشيخ وجماعة منهم (يعني أهل السنّة) إنكاره مطلقا.
وهو مذهب السيّد.
وإنطلق المانعون من منطلقين، هما:
أ- عدم جواز العمل بخبر الواحد.
على أساس أنّ ما لا يجوز العمل به لا يجوز التخصيص به.
وهو ظاهر السيّد المرتضى، قال في (الذريعة) - بعد تصريحه بالمنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد -: والذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه: أنّ الناس بين قائلين:
- ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة.
- ونافٍ لذلك.
فكلّ من نفى وجوب العمل به في الشرع نفى التخصيص به.
وليس في الاُمّة (من هو) بين نفي العمل به في غير تخصيص، وبين القول بجواز التخصيص، فالقول بذلك يدفعه الإجماع.
ويقول العلّامة الحلّي في (المباديء)(10): والسيّد المرتضى منع من ذلك لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة عنده أي أنّه لا يجوز العمل به.
ويرد هذا بما ذكرنا - في مبحث السنّة - من أدلّه تثبت حجيّة خبر الواحد وصحّة الأخذ به والعمل على وفقه، فلا أرى أيّة إفادة في الإعادة.
ب- ظنيّة طريق خبر الواحد:
ويريدون بذلك أنّ خبر الواحد مظنون الصدور عن المعصوم فيحتمل فيه الخطأ والكذب، والقرآن الكريم مقطوع الصدور إذ لا ريب في أنّه وحي منزل من اللَّه تعالى، والمظنون لا يعارض المقطوع، حتّى يصحّ لنا حمل العامّ الذي هو الآية القرآنيّة على الخاص الذي هو خبر الواحد للجمع بينهما جمعا عرفيّا.
وهو ظاهر الشيخ المفيد قال في المختصر(11): ولا يجوز تخصيص العامّ بخبر الواحد لأنّه لا يوجب علما ولا عملا، وإنّما يخصّه من الإخبار ما انقطع العذر لصحته عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أحد الأئمّة(عليهم السلام)...
وردّه العلّامة الحلي في (المباديء)(12) بأنّ عموم القرآن الكريم وخصوص خبر الواحد دليلان تعارضا فيقدّم الأخصّ جمعا بين الدليلين.
وهو من الجمع العرفي بين القرينة وذيالقرينة بتقديم القرينة على صاحبها.
يقول شيخنا المظفّر في كتابه (اُصول الفقه)(13) - بما يوضّح التعارض والجمع اللذين ذكرهما العلّامة مختصرا -: لا ريب في أنّ القرآن الكريم - وإن كان قطعي السند - فيه متشابه ومحكم (نصّ على ذلك القرآن نفسه)، والمحكم نصّ وظاهر، والظاهر منه عامّ ومطلق.
كما لا ريب أيضا في أنّه ورد في كلام النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة(عليهم السلام): ما يخصّص كثيرا من عمومات القرآن، وما يقيّد كثيرا من مطلقاته، وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره، وهذا قطعي لا يشكّ فيه أحد.
فإن كان الخبر قطعي الصدور فلا كلام في ذلك.
وان كان غير قطعي الصدور، وقد قام الدليل القطعي على انّه حجّة شرعا، لأنّه خبر عادل مثلا، وكان مضمون الخبر أخصّ من عموم الآية القرآنية، فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه وبين ان نتصرّف بظاهر القرآن، لأنّه لا يمكن التصرّف بمضمون الخبر لأنّه نصّ أو أظهر، ولا بسند القرآن لأنّه قطعي.
ومرجع ذلك إلى الدوران - في الحقيقة - بين مخالفة الظنّ بصدق الخبر وبين مخالفة الظنّ بعموم الآية.
أو فقل: يدور الأمر بين طرح دليل حجيّة الخبر وبين طرح أصالة العموم، فأي الدليلين أولى بالطرح؟ وأيّهما أولى بالتقديم؟
فنقول: لا شكّ أنّ الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرّف في ظاهر الكتاب، لأنّه بدلالته ناظر ومفسّر لظاهر الكتاب بحسب الفرض.
وعلى العكس من ظاهر الكتاب، فإنّه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجيّة الخبر، لأنّه لا علاقة له فيه من هذه الجهة - حسب الفرض - حتّى يكون ناظرا إليه ومفسّرا له.
فالخبر لسانه لسان المبيّن للكتاب، فيقدّم عليه، وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجيّة الخبر حتّى يقدّم عليه.
وإن شئت فقل: إنّ الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب، والأصل الجاري في القرينة - وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي - مقدّم على الأصل الجاري في ذي القرينة وهو - هنا - أصالة العموم.
الهوامش:
(1)- الدلالة اللغوية عند العرب/ 36.
(2)- التصور اللغوي عند الاُصوليين/87.
(3)- ص 30.
(4)- ص 95.
(5)- ص 141.
(6)- ص 95.
(7)- هو ماعز بن مالك الأسلمي الأنصاري الذي أقرّ بالزنى فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برجمه. الذي اعتبر سنة فعلية.
اُنظر قصته في كتاب (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) للشهيد الثاني: كتاب القضاء.
(8)- 2/472.
(9)- ص 305.
(10)- ص 143.
(11)- ص30.
(12)- ص 143.
(13)- 1/144- 145.