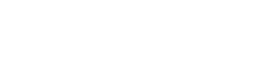محاضرات التربية الإسلامية - المحاضرة 7
تحدثنا في لقاءات متقدمة عن جملة موضوعات تتصل بالتربية وملحقاتها حيث بدأنا بالحديث أولاً عن التركيبة البشرية وصلة هذه التركيبة بالعمليات التربوية التي ينبغي أن تنطلق من إدراكٍ خاص لهذه التركيبة حتى تستطيع في ضوءها أن توجّه السلوك البشري نحو ما هو مطلوب، بعد ذلك تحدثنا عن عنصري الوراثة والبيئة وقلنا إن التصوّر الإسلامي ومثله غالبية التصورات الأرضية تتفق على أن كلاً من عنصري الوراثة والبيئة يسهمان في العملية التربوية دون أدنى شك. بعد ذلك تحدثنا عن التربية وصلتها بمراحل نمو الشخصية و هذا يعتبر - أي البحث حول نمو مراحل الشخصية، أو مراحل نمو الشخصية - من أهم المباحث التربوية التي تعنى بدراسة الشخصية وإنماء قواها نحو ما هو مطلوب.
وقلنا في حينه إن مراحل نمو الشخصية تقترن باهتمام الدارسين التربويين والنفسيين والاجتماعيين بصفة أن مراحل نمو الشخصية تتسم كلّ مرحلة منها بسمات خاصة ينبغي على المربّي دون أدنى شك أن يتقيّد بما يتناسب وهذه المرحلة، وفي حينه حدثناكم عن المراحل التمهيدية بالنسبة إلى نمو الشخصية وهي مراحل خمس: مرحلة الزواج الانتقائي، ومرحلة انعقاد النطف، ومرحلة الحمل، ومرحلة النفاس، ومرحلة الرضاعة. وقدمنا وجهة النظر الإسلامية في هذه المراحل وما تتطلبه من عمليات التحصيل الوراثي والبيئي. وكان ذلك كله تمهيد في الواقع لما نريد أن نشدّد ونركز الحديث عليه، ألا وهو مراحل النمو المتمثلة في ما يطلق عليه بمرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة والمرحلة الراشدة، وفي هذا الصدد نبدأ الآن لنحدثكم تفصيلاً عن هذه المراحل.
يمكننا أن نذهب إلى أن علماء الأرض يقسّمون نمو الشخصية إلى أربع مراحل حاسمة هي:
أولاً: مرحلة الطفولة المبكرة، وتبدأ من الولادة إلى العام السابع.
ثانياً: مرحلة الطفولة المتأخرة، وتبدأ من العام السابع إلى الرابع عشر.
ثالثاً: مرحلة المراهقة، وتبدأ من العام الرابع عشر إلى الواحد والعشرين.
رابعاً: المرحلة الراشدة، وتبدأ من العام الواحد والعشرين إلى نهاية حياة الشخصية.
هذا التقسيم الأرضي يكاد يتوافق مع التصوّر الإسلامي للتقسيم المذكور؛ ويعنينا في الواقع من هذا التقسيم صلة النمو بعملية التنشئة الاجتماعية أو التربية وبشكلٍ عام صلة ذلك بعملية التعلّم حيث قلنا أن التربية تعنى بتدريب الشخصية على تعلّم السلوك السوي بحسب تصوّرات الأرض، والسلوك السوي العبادي بحسب التصور الإسلامي.
طبيعياً إننا إذا استثنينا المرحلة الراشدة حيث تستقل الشخصية تماماً وتأخذ محدداتها العامة حينئذٍ تظل المراحل السابقة عليها، أي الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة والمراهقة، تظل هذه المراحل عرضة لتغيرات نمائية مختلفة تتسم كل مرحلة منها بخصائص معينة، بحيث تتطلب نمطاً خاصاً من التعلم أو التنشئة أو التربية بحيث تتوافق وسمات المرحلة، والحق أنه حتى المرحلة الراشدة أي المرحلة الأخيرة تظل مرشحة لأي تعلّم أو تربية أو تنشئة، بل إن التربية بمعناها النهائي في الواقع أو التعلم بمعناه النهائي يتحدد في هذه المرحلة بنحوه الواعي، أي بما يواكبه من تحمل المسؤولية كاملة لأن الهدف من التعلم أو التربية أو التنشئة عبر هذا التقسيم يظل مرتبطاً بعمليات النمو التي لا تكف جدياً إلا عند المرحلة الثالثة، ومع ذلك نقول إن عملية التعلم أو التربية تظل حتى في التصور الأرضي ممتدة من الولادة إلى الموت حتى أن ثمة مقولة معروفة لأحد الأرضيين يقول بأن (التربية تبدأ من الولادة وتنتهي بممات الشخصية) والإسلام أيضاً بدوره - وقد سبقت الإشارة إلى ذلك - لا يكف عن حث الشخصية على أن تتعلم سلوكاً جديداً يتصاعد من خلاله الشخص إلى أعلى مراحل السلوك العبادي المطلوب.
المهم إن ما نستهدف أن نشير إليه الآن قبل أن نحدثكم عن تفصيلات هذه المراحل أولاً ينبغي أن نشير إلى أن المراحل الثلاث المتقدمة، أي الطفولة الأولى والثانية والمراهقة، تبدأ موضوع عناية الباحثين التربويين والنفسيين ما دامت مرتبطة بالنمو المشخّص وصلة ذلك بعمليات التدريب وانعكاساتها على مستقبل الشخصية، أي مرحلة الشخصية الراشدة.
هنا نقول بالرغم من أن التصور الإسلامي يكاد يتوافق مع بعض الخطوط الأرضية في تصوراتها للمراحل المذكورة وجزئيات كل منها، إلا أن التصوّر الإسلامي مع ذلك يمتلك وجهة نظر خاصة تميّزه تماماً عن كلّ تصورات الأرض حيث تترتب على ذلك خطورة تربوية لا زالت غائبة عن أذهان الأرضيين، بخاصة في دور الطفولة حيث تبدو بعض الحقائق التي انتهى البحث الأرضي إليها وكأنها ثابتة في هذا الميدان، بينما يتقدم المشروع الإسلامي بما يضادها تماماً. تبعاً لذلك ينبغي أن لا نقلل من أهمية الفارق بين التصورين الإسلامي والأرضي ما دام ذلك ينسحب على مستقبل الشخصية وفقاً لما تخضع إليه من التربية التي تحدد هذا الاتجاه أو ذاك.
على أية حال إن الفارقية بين كل من الاتجاهين الإسلامي والأرضي ستتضح تماماً عندما نبدأ بدراسة المراحل الثلاث من نمو الشخصية وهذا ما نبدأه الآن بالحديث أولاً عن المرحلة الأولى.
الطفولة المبكرة
المرحلة الأولى يطلق عليها كما قلنا يطلق عليها مصطلح (الطفولة المبكرة) وتبدأ من الولادة إلى العام السابع؛ هذه المرحلة من الطفولة يخلع التربوين الأرضيون عليها طابع الخطورة، حتى أن البعض منهم ليغالي في ذلك إلى الدرجة التي يعد هذه المرحلة حاسمة في حياة الشخصية بحيث يتطبع سلوكها السابق بمقدار ما تطبعت به هذه الطفولة المبكرة، لكن ينبغي أن نشير وهذه الإشارة مصحوبة بأسفٍ كبير بأن نقول أن التربية الأرضية تقع في خطأ علمي كبير حينما تخلع على الطفولة الأولى هذا النمط من الخطورة وبخاصة تلك الاتجاهات التي تحدد الأشهر الأولى أو السنتين أو الثلاث فارزاً في سلوك الشخصية اللاحق.
ومع أننا سنناقش هذه الاتجاهات الأرضية الخاطئة في تضعيف محاضراتنا في موقع لاحق، ولكننا هنا لا مناص لنا من الإشارة إلى هذا الوهم الذي يقع فيه علماء النفس والتربية والاجتماع عبر تأكيدهم خطورة الطفولة المبكرة حينما يغيب عن أذهانهم انتفاء أهمية التعليم في السلوك وانتفاء أهمية الوعي، أو ما يسميه الباحثون الأرضيون بـ(الأنا) وقدرته على التحكم في السلوك وعلى ضبطه، بل يمكننا أن نقول أن كل محاولات التربويين وعلماء النفس العياديين ستتلاشى سدى إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن السلوك سيأخذ محدداته النهائية في السنوات الأولى من الطفولة.
ولكن لحسن الحظ أيضاً أن نقول إن كثيراً من الاتجاهات التربوية والنفسية المعاصرة، بدأت تشكك في قيمة الطفولة المبكرة وبدأت تشدد على أهمية الوعي أو الأنا والتجارب الراشدة، لكن دون أن تنفي هذه الاتجاهات خطورة الطفولة بقدر ما تتخلى عن المبالغة في تأكيدها، ولكننا عندما نتجه إلى التصور الإسلامي فسنجد المفارقة كبيرة جداً وللأسف جداً أيضاً أن نقول أن التربويين بما فيهم من يعنى بالتربية الإسلامية قد أغفل هذا الجانب إغفالاً تاماً وانساق مع الأسف مع التربية الأرضية في تأكيدها على الطفولة الأولى وعدم الانتباه على ما يقرره المشرع الإسلامي من تأكيد كما سنرى على مرحلة الطفولة الثانية، ومن تأكيد على أن المرحلة الطفلية الأولى هي مرحلة لعب وليست مرحلة تدريب أو تربية إلا في نطاق محدود كما سنرى ذلك بعد قليل.
على أية حال إن الاتجاه الإسلامي يحسم الموقف بوضوح حينما يكسب الطفولة الأولى جانباً ضئيلاً من الأهمية، وحينما يشدد في الطفولة المتأخرة وفي ضوء هذه الحقيقة يطلق التصور الإسلامي مصطلح (مرحلة اللعب) على هذه الطفولة المبكرة، أي بكلمة أكثر وضوحاً إن مرحلة الطفولة الأولى أي البادئة منذ الولادة إلى السنة السابعة تظل يطبعها طابع خاص هو طابع اللعب، وليس طابع الجد والتربية وما إلى ذلك.. ومن البيّن الذي لا يناقش فيه اثنان أن التأكيد على لعبية هذه المرحلة يعني بوضوح عدم القدرة على أن نكسب الطفل تجاربه العقلية أي طابع من التماسك والثبات، لبداهة أن نمائه العقلي لا يتناسب مع أية تجربة تربوية جادة تتطلب قدراً من النضج الذي لا تتحمّله مرحلة نماء الطفل وهو في سنواته الأولى من العمر.
لكن كما قلنا إن المشرّع الإسلامي أخذ هذه الملاحظة الصائبة بنظر الاعتبار حينما حدد طابع اللعب لا سواه طابعاً مميزاً لهذه المرحلة، ولنقرأ النصوص الإسلامية التي وردت في هذا الصدد ومنها:
قول المعصوم (عليه السلام): (دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبع سنين، وألزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فلا خير فيه).
نص آخر: (دع ابنك يلعب سبع سنين، وألزمه نفسك سبع سنين).
نص ثالث: (الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلّم الكتاب بسبع سنين، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين).
هذه النصوص الثلاثة كما ترون تشير بوضوح إلى أن السنوات السبع الأولى من الطفولة يسمها طابع اللعب، وإن السبع الثانية يسمها طابع التربية أو التنشئة القائمتين على مجرد التدريب، وإن السبع التالية (سنوات المراهقة) يسمها طابع الإلزام. وسنتحدث عن مرحلتي الطفولة والمراهقة في ضوء النصوص المذكورة وسواها ولكن ما يعنينا الآن هو لفت الانتباه على ظاهرة اللعب التي تسم مرحلة الطفولة وتأكيد النصوص الإسلامية أجمع على هذه الظاهرة مما تفصح بوضوح عن خطأ أية نظرية تخلع على الطفولة المبكرة خطورة تربوية ذات أبعاد.
لكن ينبغي أن نلفت الانتباه أيضاً على جانب آخر هو أن تأكيد المشرع الإسلامي على اللعب في هذه المرحلة لا يعني انتفاء أية أهمية على عمليات التنشئة والتدريب والتربية، بقدر ما يعني نفي الخطورة عنها ونفي وجهة النظر الذاهبة إلى أن سلوك الشخصية اللاحق يتحدد وفق التنشئة التي يتطبع الطفل عليها في سنواته الأولى. ويمكننا التدليل على لعبية المرحلة الأولى وعدم تقبلها للتدريب الجاد بما قرره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في إحدى وثائقه العيادية حيث لجأ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى عنصرٍ فني هو الاستعارة أو الرمز لكي يعمّق ويبلور ويوضّح لنا ما يعنيه من مفهوم لعبية هذه المرحلة، أي مرحلة الطفولة، وجدية ما بعدها من المراحل.
يقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين) بالنسبة إلى الحديث عن الوزير وعن العبد سنؤجل الحديث عنهما ونقبل الآن في تعليقنا على الرمز أو الاستعارة الأولى القائلة بأن الولد سيد سبع سنين، ترى ماذا يعني بكلمة (سيد)؟.
لقد أطلق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمة (سيد) على طفل المرحلة الأولى وأطلق سمة (العبد) على طفل المرحلة الثانية، وهدفه (صلى الله عليه وآله وسلم) من كلمة (سيد) واضحة تماماً حيث أن السيد لا يتلقى الأوامر من أحد، بل هو سيد نفسه ومع هذا أن الطفل لا تسمح مرحلته النمائية في سنواته الأولى بتقبّل الأوامر، أي بتقبّل التوجيه والتدريب والإرشاد والإلزام والتربية وو.. الخ، بل يتجه الطفل إلى ممارسة نشاطه بحرية لا يحدها قيد ملحوظ، إنها حرية اللعب، وهذا بعكس الطفل في مرحلته الثانية من السنة السابعة إلى الرابعة عشر حيث أطلق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لفظة (العبد) على طفل هذه المرحلة بصفة أن العبد يتلقى الأوامر ويطالب بتنفيذها أي بمعنى أنه مهيأ لعملية التدريب والتنشئة والتربية في سنواته الثانية أي من العام السابع إلى العام الرابع عشر، وأما الفقرة الثالثة من كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو أن الولد وزير سبع سنين، فهذا ينسحب على مرحلة المراهقة حيث سنفصّل الحديث لكم عن هذه الاستعارة أو الرمز الرائع الذي يجسّد في الواقع كل منحنيات المرحلة المراهقة بنحوٍ مثير للدهشة دون أدنى شك، وهذا ما نحدثكم عنه إنشاء الله في محاضرة لاحقة بطبيعة الحال.
أما الآن فنعود إلى الحديث عن الطفولة الأولى ونؤكد من جديد عدم اتسام هذه المرحلة بالأهمية التي يخلعها الأرضيون مع الأسف على خطورة المرحلة الأولى وهي خطورة وهمية بخاصة ذلك الاتجاه التحليلي الذي يرسم الطفل في مرحلة الرضاعة والمراحل الأخرى وهي مراحل تتسم بطابع أسطوري في تصوّر رائد هذا الاتجاه، ولكن لحسن الحظ كما قلنا أن الاتجاهات التحليلية ذاتها فيما بعد قد انشطرت حيال رئيسها وبدأت تركّز على المراحل الأخرى وتنفي الأهمية والتفسير الأسطوري لرائد هذا الاتجاه.
على أية حال مع أننا نقول تبعاً للتوصيات الإسلامية التي مررنا عليها وأكدت بأن الولد سبع سنين هو سيد، أو أن الولد ينبغي أن يترك للعب خلال هذه المرحلة من الطفولة، نقول: بالرغم من ذلك كله فإن المشرع الإسلامي لا ينفي الأهمية التربوية بشكلٍ تام بقدر ما ينفي الخطورة أو المبالغة التي تطبع الاتجاه الأرضي، وإلا يمكننا أن نتجه الآن إلى وثيقة تربوية مهمة للإمام الصادق (عليه السلام) هذه الوثيقة التربوية تتحدث عن الطفل منذ سنته الثالثة وحتى سنته التاسعة وترسم لنا منحنيات متنوّعة لهذه المراحل التي يقطعها الطفل في سنواته الست، أي منذ الثالثة إلى التاسعة. وسنجد أن المشرع الإسلامي، أي أن الإمام الصادق (عليه السلام) يتقدّم بتوصيات معينة يطالب فيها المربين بأن يربوا أطفالهم على هذه التوصيات، وهي توصيات تبدأ كما قلنا مع السنة الثالثة، مع أن السنة الثالثة هي ضمن مرحلة الطفولة الأولى، مما يعني إمكانية أن تتسم هذه المرحلة بشيءٍ من الأهمية التربوية ولكن في نطاق محدود وليس في نطاق عام، بل إن النطاق العام والهادف والمؤكد عليه سيتحدد بوضوح في المرحلة الثانية.
ومن الطبيعي أن هناك أيضاً بعض الملاحظات التي أبداها الإمام الصادق (عليه السلام) بالنسبة إلى هذه المرحلة، وسنقدم لكم مزيداً من الإنارة أو مزيداً من التوضيح لهذه الملاحظات حتى يقف الطالب تفصيلاً على التصوّر الإسلامي مقابل التصورات الأرضية التي خبطت في تصوراتها وذهبت مذاهب شتى يستطيع كل واحد منكم أن يقرأ عشرات أو مئات الكتب المؤلفة لتربية الطفل في هذه السنوات، وسيجد مدى الانشطارات والانشقاقات والتباينات بين مختلف الأجنحة التربوية فيما لم ترسوا على شاطئ أو مرفئ محدد بقدر ما نستطيع أن نذهب إلى التصور الإسلامي حيث يحسم لنا المواقف جميعاً بالشكل الذي سنقف عليه إنشاء الله لاحقاً.
إذن لنتقدم الآن أولاً بعرض الوثيقة العيادية، أو الوثيقة التربوية التي قدمها الإمام (عليه السلام) ليشخّص بها مراحل نمائية خاصة من الطفولة الأولى، ومراحل نمائية خاصة من الطفولة الثانية، وما يتناسب مع هاتين المرحلتين في منحنياتهما من أسلوب تربوي خاص.
إذن لنقرأ وثيقة الإمام الصادق (عليه السلام) التربوية التي بدأها بقوله (عليه السلام) ونحن في الواقع عندما نقدم هذا النص التربوي نطالب كل من يعنى بالتربية بما فيهم علماء الأرض بأن يدققوا في هذه الوثيقة ويستفيدوا منها في توجيهاتهم وتخطيطاتهم التربوية.
(إذا بلغ الغلام ثلاث سنين، يقال له سبع مرات لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له: قل محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبع مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حوّل وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلّم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صلّي حتى يتم له تسع، فإذا تمت علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليها).
إن هذا النص يمثّل وثيقة تربوية خطيرة كل الخطورة مستوعبةً لكلّ مراحل النماء العقلي عبر الطفولتين المبكرة والمتأخرة، كما أنه يحدد بوضوح منحنيات النمو من حيث عملية التعلّم أو التنشئة أو التدريب على ذلك بنحوٍ يتساوق مع النمو الإدراكي والجسدي للطفل، ولعلّ أول ما ينبغي أن نلاحظه في هذا المجال هو معرفتنا بالعبارات التي استخدمها الإمام الصادق (عليه السلام) ثم معرفتنا بالأفعال التي طالب الإمام قيام الطفل بها، حيث يلاحظ هنا أن النص قد استخدم اللغة والفعل العباديتين، أي المرتبطتين بمفهوم العبادة التي تشكل هدف السماء متمثلة في بعض ممارساتها، ألا وهي الصلاة ومقدمات ذلك من وضوء وما يترتب على ذلك من أفعال كما نصّت الوثيقة على ذلك.
لنلاحظ أولاً قبل أن نتقدم بالحديث عن منحنيات الطفولة التي أشار النص إليها، لننظر أولاً ما يلي:
تلاحظون تماماً أن هذه الوثيقة التربوية قد تركت المرحلة السابقة على السنة الثالثة، أي جعلت السنوات الثلاث الأولى خالية تماماً من أي تدريب، طبيعي أن مثل هذا الخلو يقف على التضاد تماماً من نظريات التحليل النفسي التي تذهب إلى الأشهر والسنة الأولى والثانية وما إلى ذلك من المفهومات الأسطورية التي تتحدث عن خطورة التربية في مرحلتها الأولى المتمثلة في تلكم السنوات.
المهم لقد تركت هذه الوثيقة المرحلة السابقة على السنة الثالثة خالية من أية تدريبات وجعلت السنة الثالثة هي بداية التعلّم أو القابلية على التعلّم بشكل أو بآخر. وهذا يعني أن السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل غير قابلة على التعلم بتاتاً، لأن التعلم يتطلب قدراً من المهارة العقلية ويبدو أن المهارة العقلية تبدأ بالظهور مع نهاية السنة الثالثة وهي مرحلة نمائية قد انتبه إليها بعض علماء النفس وجعلها بدايةً لمرحلة نمائية ترتبط بالمهارة العقلية، وأسماها بالمرحلة الرمزية أو التصورية.
إن الأبحاث الأرضية عندما تشير إلى عملية انتقال الطفل من مرحلة ما يسمى بـ(الإدراك الحسي) الذي يسبق السنوات الثلاث الأولى، والانتقال من ذلك إلى مرحلة الإدراك الرمزي أو التخيل فلأن تجاربها في هذا الميدان يبدو تظل متفاوتة من واحد إلى آخر من حيث تقديرها حجم مرحلة الانتقال، ولكننا كما قلنا نجد أن المشرّع الإسلامي يحسم الموقف حينما يجعل بداية القابلية على التعلم الرمزي هو السنة الثالثة من خلال العبارة التي طالبنا بتدريب الطفل عليها وهي عبارة (لا إله إلا الله).
ونحن ندعو الطالب أن يتأمل هذه العبارة بدقة وأن يوجه كل اهتمامه لفهم هذه العبارة حتى يدرك بوضوح أهمية ما أشار الإمام الصادق (عليه السلام) إليه من هذه العبارة.
لاحظوا أن هذه العبارة تستدعي في الواقع نمطاً من التفكير الرمزي، أو التخيلي أو التصويري الذي أشار إليه بعض علماء الأرض من أنها تبدأ بعد مضي ثلاث سنوات من عمر الطفل، المهم أن الطفل في ضوء الوثيقة المذكورة يبدأ مع هذه السن بتجاوز مرحلة الإدراك الحسي إلى مرحلة الإدراك الرمزي، وكلكم يعرف أن الطفل في سنواته الأولى يتعامل مع الواقع من خلال الحس، أي من خلال الحاسة البصرية والسمعية ونحو ذلك، وحينما نتجه إلى العبارة التي طالب الإمام (عليه السلام) بتدريب الطفل عليها وهي عبارة (لا إله إلا الله) فماذا نجد؟
نجد أن هذه العبارة أن الطفل سوف يبدأ بتجاوز ما يحيط به من ظواهر حسية تقع تحت سمعه وبصره ولمسه لتجاوز ذلك إلى إدراك بعض العلاقات بين الظواهر المحسة ذاتها، من حيث المكان وإدراك بعض الآنات الزمانية كالحاضر وعلاقته بماضي الطفل، أو بمستقبل خبرات الطفل التي يتوقع الطفل حدوث نظائرها.
إن إدراك مثل هذه العلاقات تجسدها بوضوح عبارة (لا إله إلا الله)، لأنها تربط بين موجودات أو عينات حسية خبرها الطفل في ماضي حياته وبين موجود بين لم يخبره بعد، ولكنه موجود غير محسوس، وسيتضح هذا بعد أن نقرأ العبارة الثانية التي طالبنا الإمام الصادق (عليه السلام) بتدريب الطفل عليها.
لاحظوا أن الإمام (عليه السلام) يقول مع تقدم الأشهر والأسابيع والأيام يبدو أن الطفل يصل إلى مرحلة نمائية جديدة، أي بعد مرور مئتين وثلاثين يوماً بحيث يتطور إدراكه الرمزي للظواهر بنحو يسمح له بإدراك العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا ما تفصح عنه العبارة التي طالبنا النص بتدريب الطفل عليها من خلال قوله (عليه السلام): (ويترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً، فيقال له: قل محمد رسول الله)، ومن البين أن الإدراك الرمزي عند الطفل بعد أن تكون له خبرة بالله تعالى، فإن العلاقة بين عبارة (الله) وعبارة (الرسول) تبدو من الوضوح بمكان كبير من حيث تطوير الإدراك الرمزي، بمعنى أن الطفل يبدأ بإحداث علاقة بين ظاهرتين تستندان إلى الرمز، أو التصور، أو التخيل. في حين كان إدراك الطفل في المرحلة السابقة قائماً على العلاقة بين ظاهرتين، إحداهما حسية وهي خبراته في سنينه الثلاث، والأخرى تجريدية وهي لفت ذهنه إلى عبارة الله.
وبكلمات أخرى إن طرفي الإدراك في المرحلة الأولى هما حسي زائداً تجريدي، في حين أن طرفيه في المرحلة الثانية هما تجريدي زائداً تجريدي، فعبارة الله هي الطرف الأول تجريدي، وعبارة محمد تجريدية أيضاً من حيث محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يضطلع بمهمة الرسالة لا من حيث كونه شخصاً، وإلا فإن إدراكه كشخص يظل حسياً، في حين أن إدراكه كرسول يحمل دلالة تجريدية من حيث عدم اختمار معنى الرسالة في ذهن الطفل كما هو واضح.
والآن نتجه إلى المرحلة النمائية الثالثة من حياة الطفل بعد مرور مئة وثلاثين يوماً أي عند بلوغ الرابعة من العمر، حيث يطالبنا النص الوارد عن الإمام الصادق بتدريب الطفل على عبارة (اللهم صل على محمد وآل محمد)، وترون أنه من الوضوح بأن هذه المرحلة الجديدة من النمو تفصح عن تطور ملحوظ في الإدراك الرمزي للطفل، ويتضح لكم هذا حين نلحظ أن الصلة بين التطوّر الجديد للإدراك وبين عبارة (اللهم صل على محمد وآل محمد) تتمثل في حذف أطراف العلاقة بين عبارة (الله) وعبارة (محمد) حيث يترك للطفل أن يمارس إدراكاً مستقلاً هو الصلاة على محمد وآله بغض النظر عن كونه رسولاً لله تعالى، أي أن الطفل في المرحلة الجديدة من الإدراك إنما يستجيب لمفهوم له استقلاله وليس لمفهوم يتطلب إدراك علاقة بين ظاهرتين.
والآن لاحظوا لقد كانت المرحلة الأولى من النمو تنطوي على إحداث علاقة بين عالم حسي عند الطفل وعالم تجريدي، عالم الطفل الخاص والعالم الجديد. وأما في المرحلة الثانية من النمو كان إحداث العلاقة بين العالم الجديد نفسه أي الله سبحانه وتعالى فيما كون الطفل عنه خبرة نسبية وبين عالم جديد آخر هو كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رسولاً لله تعالى، أما المرحلة الثالثة من النمو فتنطوي على تطوير إدراكي جديد قائم على حذف العلاقة القديمة أساساً وإدراك شخصية محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بنحو مستقل دون استحضار الأطراف السابقة أي طرفي (الله) و(الرسول).
والآن نواجه مرحلة جديدة من النمو تبدأ مع بلوغ الطفل السنة الخامسة، وهذه المرحلة تلفت انتباهنا إلى الفارقية بين الأطفال في عملية التعلم، ولعلكم تعرفون تماماً بأن الأبحاث الأرضية قد انتبهت على وجود فوارق بين الأطفال من حيث النمو العقلي لديهم، ودرجة تقبلهم لعملية التعلم في هذا الصدد. حيث تتراوح السن الخاضعة للتفاوت بين الأطفال بين الخامسة والسادسة، مع ملاحظة أن السنة السادسة هي المرحلة الحاسمة للنمو عند غالبية الأطفال، حيث تبدأ معها الدخول إلى الدراسة في المرحلة الابتدائية، ولكن من الملاحظ أن بعض الأطفال - وهذا ما لاحظه جمع من علماء النفس والتربية والاجتماع - ترشحهم السن الخامسة إلى الدخول في الدراسة الابتدائية، ونحن حين نتجه إلى الوثيقة الإسلامية في هذا الميدان نجدها قد ألقت إنارة كاملة على هذا الجانب، ولكن بما أن هذا الجانب يتطلب مزيداً من إلقاء الإنارة ومزيداً من التوضيح، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن علماء النفس والتربية يعنون بهذا الجانب عناية كبيرة، حيث يضطلع أحد فروع علم النفس والتربية بتبيين الفوارق بين الأفراد ومن ذلك الفارق في مهاراتهم العقلية، وهذا ما توفر الإمام الصادق (عليه السلام) عليه حينما وضع معياراً للاختبار، علماً أن علماء النفس والتربية قد وضعوا جملة اختبارات ومقاييس لتحديد الفوارق بين الأفراد، والأهم من ذلك كما قلنا أن الإمام الصادق (عليه السلام) عندما يضع معياراً أو مقياساً بسيطاً لتبيين الفارقية فإن هذه البساطة في المعيار تكشف في الواقع عن عمق في الدلالة وهو أمر يتطلب كما كررت مزيداً من إلقاء الإنارة عليه حيث نتوفر على ذلك إنشاء الله في محاضرة لاحقة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..